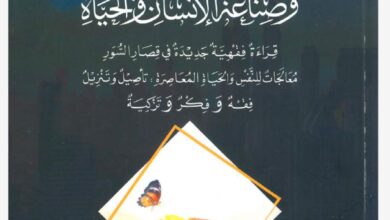دور وثيقة المدينة المنورة في السلام العالمي
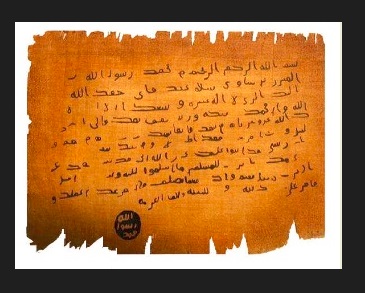
د. علي محمد محمد الصلابيّ
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تمهيد :
الحمد لله، الأكرم، كرّم الإنسان بمجرد خلقه إنساناً، فقال:﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (الإسـراء:70)، ومنحه الإرادة وحرية الاختيار والاعتقاد، أراد له أن يريد، وجعله مسئولا عن اختياره، فالمسئولية فرع الحرية، وزوده بالعقل وأهَّله للمعرفة، وهداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، بمعالم وأدلة واضحة بارزة، واعتبر الإكراه والإجبار حطا من كرامة الإنسان وانتقاصا من إنسانيته، فقال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (البقرة:256).
إن حرية التدين، أو اختيار الدين، تعتبر من أرقى أنواع الحرية والاختيار وأعلاها وأسماها، لذلك فالإكراه على الدين يناقض كرامة الإنسان من جانب، كما يناقض قيم الدين ونصوصه من جانب آخر، فحرية التدين قيمة أساس في المجتمع الإسلامي، وعدم الإكراه والقبول بصاحب الخيار والمعتقد (الآخر) هـو استجابة لأوامر الدين والتزام بقيمه، قال تعالى مخاطبا المؤمنين به: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾، فالمطلوب إليهم هـو بيان الرشد من الغي وترك الحرية للناس، فالإكراه يضع أقنعة مزيفة ولا يحقق قناعة، ويخلق إنسانا مزيفا منقوص الإنسانية، ويزيد من مساحة النفاق والمنافقين.
وتعد السيرة النبوية عطاء مفتوحاً لكل زمان ومكان، فهي من عطاء قيم الوحي الخالدة، التي تجسدها في الواقع وتنـزلها على حياة الناس، هـي خالدة كخلود القيم، بل هـي سنة وقيمة ومعيار أيضا، يتطلب النظر والاجتهاد فيها تجريدها عن حدود الزمان والمكان والإنسان وتوليدها في كل زمان ومكان، عطاءً لا ينضب بمرور الزمن، فمرحلة فيها لا تلغي مرحلة، والنظر في زمن لا يلغي النظر في زمن آخر، والنصر لا يلغى الهزيمة، والهزيمة لا تلغي النصر، والفترة المكية لا تلغي الفترة المدنية، ولكل حالة حكمها وآلية التعامل معها.. وفتح باب الاجتهاد الفكري على مصراعيه لكل الناس يؤدي إلى الانفعال بأحداث السيرة، والتفاعل معها، والتمحور حولها؛ فالإسلام فضاء لا يحده الزمان والمكان، نزل لكل البشر، سواء كانوا من أمة الإجابة أو أمة الدعوة؛ والعلماء العدول هـم الذين يحملون الحقيقة ويدفعون التفسير الغالي والتأويل الجاهل والانتحال الباطل.
وتعتبر السيرة مرحلة بناء الأنموذج، الذي أتى على أصول الحياة جميعا، حيث تعد دليلا لكيفية التعامل مع حياة الناس، وتنـزيل قيم القرآن عليها؛ فهي كالمنجم الغني بالخامات الثمينة، وهذه الخامات تتطلب البراعة والاجتهاد في تصنيعها وتحويلها إلى أوعية للحركة وتقديم الحلول لكل النوازل وتطورت الحياة.. ولعل المساحات الكبيرة التي قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتى أنواع التعامل من التصالح والتسالم والتحاور والتعاهد والتعاقد والتصالح والتحالف والمواجهة، تحتل جزءا مهما من حوادث السيرة، وإن كان الكثير من المسلمين قد غفل عنه بسبب التخلف، وما نتج عنه من التعطيل والنسخ… إلخ، حيث أسبابه ونتائجه انعكست على الفهم السليم المتوازن للسيرة والتعاطي معها بشكل عام.
فقد خاطب الرسول الملوك وراسلهم، وأذن لأصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة (حكم غير إسلامي)، لأن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده؛ ونزل بعد العودة من الطائف ، في رحلة الشدة الشديدة، بجوار المطعم بن عدي وشاركه في الحصار في شعـب أبي طالب غير المؤمنـين من أصحابه، إذ لما أجمعت قريش على أن يقتلوا رسول الله ، وبلغ ذلك أبا طالب، جمع بني هـاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله شِّعْبهم ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك، حتى كفارهم، فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية .
وحضر حلفاً في الجاهلية، وكان له من العمر عشرين عاما، كما تروى بعض كتب السيرة في دار عبد الله بن جدعان في مكة ، حيث تعاقد أهلها أن لا يبقى في مكة مظلوما إلا وترد إليه ظلامته، وبارك ذلك العمل في الإسلام، لأنه يحقق مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك على يديه؛ روى الحميدي أن ﴿ رسـول الله قال: «لقـد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما ﴾.
وعاهد قريشاً في صـلح الحديبية ، وسمي ذلك «الفتح المبين»، ودخل في حلفه خزاعة ، وكانت على الكفر: «فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسـول الله وعهده»، فالمعاهدة مع غير مسلمين، والتحالف مع غير مسـلمين أيضا، حيث دخـلت بنو بكر ، وكانت على الإسلام، في حلف قريش.
وبعد الرسـول سار صحـابته على خطـاه، فوقع سيدنا عمر ابن الخطاب ، رضي الله عنه، عهدا مع أهل أيليا سمي «بالعهدة العمرية»، ومن نصوصها: «هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل أيليا من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضارَّ أحد منهم… » هـذه بعض البنود المهمـة في الوثيقـة أو العهدة العمرية التي شهد عليها من الصحابة – وهذا له دلالة أيضا – خـالد بن الوليد ، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف ، معاوية بن أبي سفيان .
لذلك نقول: إن حلف الفضول، وصحيفة المقاطعـة في شعب أبي طالب، والنـزول بجوار المطعم بن عدي، والسماح بالهجرة إلى أرض الصدق والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عنده، وصلح الحديبية، و«وثيقة المدينة»، و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدس، كلها معالم رئيسة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)، يستدعي الاجتهاد والنظر والتفكير وإيجاد الصيغ الملائمة لتعامل المسلمين مع (الآخر)، ذلك أن (الآخر) موجود، وأن التنوع بالعقائد والأفكار والألوان والأقوام والأجناس سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق معها على صيغ وقواسم مشتركة، وأن الاعتراف بوجود (الآخر) كواقع، والتعامل معه، والتوافق معه على صيغ تعاون لا يعني إقراره على ما هـو عليه، فله خياره ولا إكراه.
إن هـذه الوثائق التي أتينا على ذكرها دليل على الفضاء الواسع للقيم الإسلامية وإنسانيتها، فضاء لا يحده الزمان ولا المكان، وإنما تحدده الرؤية القاصرة والفقه العليل والتعصب الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن التعصب يتناسب طردا مع قلة العلم والمعرفة.. إن انفتاح العالم، وحقبة العولمة، ومعاهدات الشراكة على المستويات السياسية والاقتصادية
لقد كان لدستورها قصب السبق بالنسبة لكل دساتير العالم، فهو يعتبر أول تجربة سياسية إسلامية في صدر الإسلام بقيادة الرسول ، فقد كان له دور بارز في إخراج المجتمع من دوامة الصراع القبلي إلى رحاب الأخوة والمحبة والتسامح، إذ ركز على كثير من المبادئ الإنسانية السامية كنصرة المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، وتحريم الجريمة، والتعاون في دفع الديات، وافتداء الأسرى، ومساعدة المدين، إلى غير ذلك من المبادئ التي تشعر أبناء الوطن الواحد بمختلف أجناسهم وأعراقهم ومعتقداتهم أنهم أسرة واحدة مكلفة بالدفاع عن الوطن أمام أي اعتداء يفاجئهم من الخارج. فالمساواة قامت بينهم على أساس القيمة الإنسانية المشتركة؛ الناس جميعا متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسئولية، وأنه ليس هـناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني وخلقها الأول.
أهمية الوثيقة وتاريخها ووحدتها :
تشكل «وثيقة المدينة»، العقد الاجتماعي الأول في تاريخ البشرية، والذي يعدّ أهم مرتكزات دولة المدينة ، وقد صرحت المصادر بأن «الوثيقة» تمت أول قدوم الرسول إلى المدينة وألحقت كل قوم بحلفائهم، قال الواقدي: «لما قدم رسول الله المدينة وادعته يهود كلها، وكتب بينه وبينها كتابا وألحق رسول الله كل قوم بحلفائهم، وجعل بينه وبينهم أمانا، وشرط عليهم شروطا، فكان فيما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا، فلما أصاب رسول الله أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما بينها وبين رسول الله من العهد» .. صرح الواقدي بأن «الصحيفة» كانت بين سكان المدينة قبل بدر ، يتضح ذلك جليا من خلال الأحلاف التي كانت بينهم قبل مجيء الرسول إليهم فأقرهم على أحلافهم «وألحق رسول الله كل قوم بحلفائهم» وهذا ما يجعلنا نجزم بأنها تمت بين الجميع.
يقول البلاذري (ت 276 هـ) «إن رسول الله لما قدم المدينة، وادعته يهودها كلها، وكتب بينه وبينهم كتابا، فلما أصاب أصحاب بدر وقدم المدينة سالما غانما موفورا، بغت وقطعت العهد» . وهكذا أكد البلاذري أن موادعـة الرسـول لليهود كانت قبل غزوة بدر، ولكنه لم يذكر «الوثيقة» التي توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم سواء قبل بدر أو بعدها، ولا نظن أنه قد أهمل ذكرها، وإنما يغلب الظن أنه خص بالذكر موادعة اليهود من «الوثيقة»، وهو يتحدث عن سبب غزوة بني قينقـاع والتي كانت نتيجة لما أظهره هـؤلاء من الحسد والبغي والنقض للعهد، وهذا ما سـار عليه أبو جعفر الطبري (ت 310هـ) إذ يقول: «ثم أقام رسول الله بالمدينة منصرفه من بدر، وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها، على ألا يعينوا عليه أحدا، وأنه إن دهمه بها عدو نصروه، فلما قتل رسول الله من قتل ببدر من مشركي قريش أظهروا له الحسد وقالوا: لم يلق محمد من يحسـن القتال، ولو لقينا لاقى عندنا قتالا لا يشبهه قتال أحد، وأظهروا نقض العهد» .
نلاحظ أن الطبري يتفق مع البلاذري في مناسبة ذكر موادعة اليهود وهي عودة النبي من موقعة بدر غانما وظهور غدر اليهود بنقضهم العهد، وهو ما يسـتوجب تخصـيص ذكر من أحدث وغير ما تم الاتفاق عليه وما ترتب عن ذلك من أخطـار هـددت أمن المجتمع المديني ووحدته. كما وردت «الوثيقة» بنفس الروايات السابقة في «الكامل في التاريخ وتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» .
وكذلك نجد المراجع الحديثة اهتمت بدراسة «الوثيقة» من ناحيتها التاريخية، فقد اختلفت آراء المؤرخين المسلمين والمستشرقين حول تاريخية «الوثيقة» ووحدتها، فمنهم القائل بأنها وضعت غداة وصول الرسول إلى المدينة، فكانت بمثابة أول دستور وضع في الإسلام، يعيش في ظله المسلمون وأهل الكتاب على السواء . ومنهم القائل: بأن النبي وضع دستورا ينظم الحياة العامة في المدينة ويحدد العلاقات بينها وبين جيرانها قبل انصرام العام الأول للهجرة ، أي قبل موقعه بدر .. ويؤكد أحمد إبراهيم الشريف أن «الوثيقة» كتبت قبل بدر قائلا: «ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هـذه الدولة الإسلامية، فإنما تقوم الدول أولا ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور، ولكن النبي ما كاد يستقر في المدينة وما كاد العام الأول من هـجرته إليها ينتهي حتى كتب هـذه «الصحيفة» التي جعل طرفها الأول المهاجرين، والطرف الثاني الأنصار، وهم الأوس والخزرج ، والطرف الثالث اليهود من أهل يثرب» .
بينما نجد بعض المؤرخين، وهم قلة، يقول: إن هـذا الكتاب «أصدره الرسول بعد ثبات كيان الإسلام على إثر انتصاره في موقعة بدر الكبرى، ذلك الانتصار الذي كان مبعث قوة معنوية كبيرة للمسلمين، وهو أول دستور شامل ينظم شئون الأمة في المدينة» .
أما الفريق الثالث فهو صاحب الرأي القائل بأن «الوثيقة» في الأصل وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة اليهود كتبت قبل بدر أول قدوم النبي إلى المدينة، والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم وكتبت بعد موقعة بدر الكبرى لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين .
وهناك رأي رابع يذهب إلى أن «الوثيقة» تشتمل على سلسلة من المعاهدات المنفصلة ضمت دون تمييز وجمعت في مكان واحد، فتبدو متداخلة في بعض المواضع ومكملا بعضها بعضا في مواضع أخرى، فمن ذلك تكرار فقرات بأكملها تنص على التزامات وشروط واحدة كما هـو الحال في الفقرتين: (23 و42) اللتين تنصان على رد أي خلاف ينجم بين المتعاهدين إلى الله ورسوله، والفقرتين: (24 و38) اللتين تنصان على أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، والفقرتين: (37 و44) اللتين تنصان على مناصرة الأطراف لبعضهم بعضا على من دهم يثرب، والفقرتين: (30 و46) اللتين تتحدثان على ما ليهود بني الأوس من حقوق، والفقرتين: (37 و45ب) اللتين تذكران نفس الشروط حين تتحدثان عن النفقات التي تلزم جانبي اليهود وبقية الأمة في يثرب، والفقرتين: (20ب و43) اللتين تحرمان إجارة قريش ومالها .
أما آراء المؤرخين المستشرقين حول تاريخ وضع «الصحيفة» ووحدتها فقد ذهب بعضهم أمثال ( فلهاوزن ) و (ولفنسون ) و( كايتاني ) إلى أنها وضعت قبل بدر، ويضعها « هـدبيرجريم » بعد موقعة بدر ويذهب بعض آخر من المستشرقين كـ «مونتجومرى واط» إلى القول: بأن «الوثيقة» تعود في شكلها الحاضر إلى عام 627 م وهو العام الذي انتهى فيه إبعاد أو تصفية القبائل اليهودية الرئيسية الثلاث (قينقاع ، النضير وقريظة).
وأيا ما كانت الآراء حول تاريخية «الوثيقة»، فإن المصادر الإسلامية التي رجعنا إليها والتي أوردت «الصحيفة» كاملة أو نتفا منها، شبه مجمعة على أنها تخص المهاجرين والأنصار وموادعة يهود المدينة بعد هـجرته إلى المدينة، وقبل موقعة بدر الكبرى .
والذي أراه وأطمئن إليه هـو أن «الوثيقة» قد كتبت بعد الهجرة وقبل موقعة بدر الكبرى، وأنها شملت القبائل العربية واليهودية كلها، التي ورد ذكرها على هـيئة بطون بما يتوافق مع تركيبة القبيلة العربية وأحلافها؛ لأن القبيلة اسم عام ينضوي تحته عدة طوائف لكل طائفة الحق في عقد الأحلاف مع البطون الأخرى بمعزل عن القبيلة الأم.
مدى توافق بنود «الوثيقة» مع نصوص الكتاب والسنة :
إذا كان رسول الله قد انفرد من بين جميع الأنبياء بأن عقد أكبر وأعظم وثيقة سياسية لم يسبقه إليها نبي ولم تتجاوزها في روحها ودلالتها أي وثيقـة تاريخـية معروفة الـيوم، فلنا أن نتسـاءل -إذا كان الأمر كما أسلفنا- عن مدى توافق بنودها مع نصوص الوحي؟
وللإجابة عن ذلك نشير إلى أن هـذه «الوثيقة» الحضارية التي وضعها الرسول منذ بزوغ فجر الإسلام بالمدينة المنورة، واستكتبها أصحابه، ثم جعلها الأساس المتفق عليه في ما بين المسلمين وجيرانهم اليهود والوثنيين من سكان المدينة، تتفق بنودها مع النصوص الإسلامية التأسيسية (المقدسة) في المبادئ العامة حيث تتوافق مع نصوص الوحي من حيث المعنى.
وثيقة المدينة وأثرها الاجتماعي في السلام العالمي
أولاً: أساس المواطنة في الدولة:
كانت يثرب قبل قيام الدولة الإسلامية مقسمة إلى خمسة أجزاء، كل جزء منها تسيطر عليه قبيلة من القبائل، سواء كانت عربية أو يهودية، ويعيش على ذلك الجزء مختلف البطون والعشائر للقبيلة الواحدة، وكانت كل قبيلة تشكل وحدة الحياة الاجتماعية، وفي مضمونها وحدة الحياة السياسية المستقلة بنفسها. وقد كان الخلاف بين مختلف القبائل مستحكما، فيهود بني النضير وقريظة نكلوا بيهود بني قينقاع وأخرجوهم من ديارهم ومزارعهم وسفكوا دماءهم، جريا وراء مصالحهم الشخصية، وقد ندد القرآن الكريم بأعمالهم .
أما العرب – الأوس والخزرج- فقد تمكن اليهود، عن طريق الدسائس والمؤامرات، أن يلقوا العداوة والشحناء بين الفريقين، فكانوا يعيشون دائما في حروب دامية متواصلة، كان آخرها حرب (بُعاث) قبل الهجرة بخمس سنوات.. فالتنافر بينهم مستحكم، والعداء مزمن، منذ أمد بعيد.
وكان كيان العرب الاجتماعي الطبيعي ينمو وتتشابك أغصانه، وترسو جذوره في إطار القبيلة فقـط الذي يرأسها «شيخ» هـو لها بمقام الملك، وتكونت الدولة الإسلامية، منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة الرسول وعلى أساس دستوري مكتوب، من رعايا مختلف الديانات: المسلمون من المهاجرين والأنصار، وأهل الكتاب من اليهود، وبقايا مشركي المدينة؛ وقد أطلق عليهم رعايا الدولة الإسلامية «وإن كان معنى (الرعية) كما جاء في الحديث الشريف ، ينطبق على عدة صور من المسئولية، إلا أن القدر المشترك هـو رعاية جميع حقوق الرعية… ورعاية جميع الحقوق المشروعة هـي لب كلمة “المواطنون” بحسب المصطلح المعاصر فلا وجه للتفريق بين مدلول الرعايا والمواطنين في المجتمع الإسلامي».
– مفهوم المواطنة :
تشير دائرة المعارف البريطانية (3/332) إلى أن «المواطنة علاقة بين فرد ودولة، كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة». وتؤكد أن «المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصحبها من مسئوليات»..
– الجنسية في الشريعة الإسلامية :
كان الفقهاء يطلقون على الدولة الإسـلامية اسـم ( دار الإسلام )، كما كانوا يصفون الأفراد الذين يستوطنون فيها بأنهم ( أهل دار الإسلام ) أي من أتباع الدولة الإسلامية، وكان ارتباط الأفراد بالدولة ارتباطا خاصا، لا يشبه ارتباط الفرد بالفرد؛ لأن الدولة الإسلامية ليست فردا، وإنما هـي منظمة سياسية، كما لا يشبه ارتباط الفرد بالأمة، لأن الأمة ليست منظمة سياسية كالدولة، فرابطة أفراد شعب (دار الإسلام) بهذه الدار رابطة سياسية وقانونية؛ لأن الدولة الإسلامية وهي منظمة سياسية طرف فيها، ولأن آثارا قانونية تنتج عنها، ويلتزم بها الفرد والدولة، فهذه الآثار هـي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في ظل الدولة والواجبات التي يلتزم بها قبلها، وهذه الرابطة هـي الجنسية بمفهومها الحديث، وإن لم يسمها الفقهاء بهذا الاسم .
– الجنسية في المفهوم المعاصر :
هي «نظام قانوني، تضعه الدولة»، لتحدد به وضع الشعب فيها، ويكتسب عن طريقه الفرد صفة تفيد انتسابه إليها» . فالجنسية صفة في الفرد تفيد انتماءه إلى الدولة وعضويته في شعبها.. ليس هـذا فحسب، بل إن هـذه الصفة تنبثق عن شعور نفسي وروحي تجسده وتدل عليه.
هذا المفهوم المركب للجنسية نجده في الدولة الإسلامية قديما بوجود تلك الرابطة الروحية والاجتماعية التي تربط الأفراد بالدولة، وإن اختلف أساس وجود هـذه الرابطة والآثار المترتبة عليها لاختلاف المصدر «القانوني» الشرعي المنشئ لها .. فقد عاش المسلمون مع غيرهم ممن يخالفونهم في العقيدة، يشاركونهم الحياة المجتمعية في رابطة إنسانية نابعة من الإسلام، ذلك أن «دستور» المدينة يقرر «أن المواطنة في الدولة الإسلامية تتسع لتشمل غير المسلمين من أبناء الوطن الأصليين، وأولئك الذين يختارون أن ينضموا إلى جماعة الإسلام السياسية» . فالمواطنة في الدولة الإسلامية الأولى لم تنحصر في المسلمين وحدهم، بل امتدت لتشمل اليهود المقيمين في المدينة، واعتبرتهم «الوثيقة» من مواطني الدولة – أمة مع المؤمنين – وحـددت ما لـهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
وتنص الوثيقة على واجبات المشركين من أهل المدينة، مما يشير إلى أنهم دخلوا في حكم الدولة الجديدة وخضعوا لأسس تنظيمها التي وردت في وثيقتها، وأوضح هـذه البنود البند رقم (20ب): «وأنه لا يجير مشـرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن».
والمواطنة لا تساوي الانتماء الديني دائما، بل يمكن أن تفترق عنه حين يكون المجتمع السياسي مكونا من فئات ذات انتماء ديني متنوع؛ وقد يتساويان كما في حال وجود مجتمع ذي انتماء ديني واحد، فيلتقي مفهوم الأمة مع مفهوم الدولة و(المواطنة)، كما يمكن أن يكون هـناك وطن واحد يضم أمتين، كما هـو الحال في «الصحيفة» التي تعالج علاقات الأمتين الإسلامية واليهودية، فهي لم تحرم حق المواطنة على غير المسلمين، ما داموا يقومون بالواجبات المترتبة . ويترتب على انتماء المتعاقدين للدولة، وفقا للبنود الواردة في «الوثيقة»، أن ينعم أهلها، من المسلمين وغير المسلمين، بالعصمة في أنفسهم وأموالهم، فهم جميعا آمنون بأمان الإسلام.
– مواطنة المسلم :
اعتبر الرسول أن أساس (المواطنة) والانتماء لهذه الدولة هـو الهجرة إليها، فعلى من يريد أن يكون مواطنا في مجتمع المدينة أن يهاجر إليها، لكي يتحقق في المسلم الذي يسكن في الدولة الإسلامية رابطان أساسيان هـما: الإيمان أولا، والولاء للنظام المعمول به في الدولة ثانيا؛ أما المسلمون الذين يفضلون التوطن خارج حدود الدولة الإسلامية فلا يعدون من مواطني الدولة الإسلامية لانقطاع الولاية، وإن لم يمنع من وجوب النصر عند تعرضهم للاضطهاد في الدين، والأصل في هـذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (الأنفال:72)، فهذه الآية الكريمة تتوافق مع بنود «دستور» الدولة الإسلامية الذي وضعه الرسول بالمدينة بين «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم».
– مواطنة غير المسلم:
أما بالنسبة لغير المسلمين فأساس المواطنة هـو «الولاء» للدولة الإسلامية عن طريق العهد؛ لأن حق المواطنة لا يستلزم وحدة العقيدة ولا وحدة العنصر، قال : «لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وهذا الدليل يتوافـق مـع ما نص عليه دستور المدينة في الفقرة الأولى والثانية من البند رقم (25) الذي قرر المواطنة المتساوية لليهود وغيرهم … وعلى من يكتسب هـذا الحق أن يقوم – نظير ذلك- بواجبات مؤداها تحقيق التكافل مع الدولة، والولاء لها، لحفظ كيانها، وفي هـذا دلالة على أمرين:
الأول: تأصيل مبدأ حرية العقيدة، وهو من المبادئ الأساس التي تقوم الدولة الناشئة.
الثاني: مبدأ التسامح مع أهل الأديان السماوية الأخرى.
لقد وفرت «الصحيفة» لغير المسلم في المجتمع الإسلامي وجودا اندماجيا يحافظ فيه على جميع مكونات شخصيته، وفي طليعتها المكون الديني وما يرتبط به من ممارسات وعادات، بها يؤكد ذاته عقديا وثقافيا ونفسيا، مما يتحقق به الانتماء إلى ذلك المجتمع .
- عقد الذمة : تعطى الذمة لأهلها من غير المسلمين، وهي ما يشبه في عصرنا الحاضر – الجنسية السياسية- التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنة التي تربطهم، بالدولة الإسلامية، برباط الولاء والتبعية، وبالتالي يتمتعون بالحقوق المدنية والدينية والإنسـانية، وقد حذر الإسلام من اضطهاد المسلم لغير المسلم فقال (: «أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
ثانياً: تحديد مفهوم الأمة ودورها في توحيد المجتمع
لم يكن مفهوم الأمة في العرف العربي يتجاوز الأسرة الكبيرة التي تمسكها رابطة الرحم القريبة، وتجمع أفرادها في أسرة واحدة، وتتقدس فيما بينها -تلقائيا- قرابة الدم … فوحدة الدم هـي التي تسود روح الجماعة، وفي ظلها قام قانونها العرفي، الذي ترسي على أساسه علاقاتها بأفرادها وسياستها مع غيرها ، لذلك «كان طبيعيا أن يضع العرب في مطلع القرن السابع (الميلادي) مفهوم «القبيلة» في مركز الصدارة في تفكيرهم السياسي، إذ لم يكن لدى غالبية العرب هـيئة سياسية أخرى غير القبيلة» .
– الأمة من خلال بنود «الوثيقـة» :
هـي كيان اجتماعي سياسي، تقوم على أساس الفكر والعقيدة لا على أساس الدم أو على أسس بيولوجية، لا تحدها لغة أو جـنس أو وطن، ولا تصادر الأفكار والعقائد الأخرى، بل لها من الرحابة ما تستوعب بـه العناصر الأخرى دون صهر أو تذويب، قابلة للتوسع والتقلص تبعا لعدد من ينضم إليها أو يتركها باختياره .
تعتبر«وثيقة» المدينة الدعوة إلى التحرر من رواسب الماضي، كالنـزعة العصبية والثارات الجاهلية، وامتصاص الصراع التقليدي بين الأوس والخزرج، حيث تنص على أن «المؤمنين والمسلمين سواء كانوا من (مكة) أو (يثرب) يشكلون مجتمعا موحدا»؛ وفكرة الوحدة فيه ترتكز على وحدة الانتماء إلى العقيدة الجديدة، التي هـي رسالة الأمة، وشرط تكونها الجديد «الوحدة»: ﴿ إِنَّ هـَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء:92) . والفرق هـنا بين الإسلام والإيمان: أن الإسلام هـو انقياد ظاهري ونطق بالشهادتين، أركانه وأعماله ظاهرة، كالخضوع لأحكامه وفرائضه، بخلاف الإيمان، فإن التصديق بالقلب ركن من أركانه، وهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. ويتضح لنا الفرق بين الإسلام والإيمان في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ… ﴾ (الحجرات:14)، ويتميز الصنفان في أهل يثرب فقط لظهور النفاق فيهم، أما المهاجرون فليس فيهم مسلم إلا وهو مؤمن مصدق بقلبه، وهذا التمايز هـو ما قصدته «الوثيقة» في البند رقم (1) الذي نص في إحدى فقراته على أن المؤمنين والمسـلمين – الذين كانوا النواة الأولى لتأسيس الأمة والدولة النظامية في يثرب، التي أنشأها النبي على أساس دستوري – من قريش وأهل يثرب «أمة قامت على أساس الفكرة والعقيدة».
وبينت «الوثيقة» -البند رقم (2)- الانتظام الاجتماعي الجديد للمؤمنين والمسلمين: «أنهم أمة واحـدة من دون الناس» لا تتلفع بالعصبية ولا تتسم بالعنصرية ، ولا تأخذ من الطبقية ، فالمؤمنون والمسلمون من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بـهم وجاهد معهم «أمة واحدة»، والجديد في هـذا المبدأ أنه الجذر الأساسي للاعتـراف بتكوين «الأمة» للمرة الأولى في تاريخ جزيرة العرب السياسي، وأنها وحدة واحدة لا تتجزأ… وهنا نشـعر بالانتقال الكبير في حياة العرب من حياة الفرد والقبيلة إلى حياة الأمة الواحدة .
ومن هـنا يتبين لنا «أن المجتمع السياسي ، الذي أنشأته الوثيقة، هـو مجتمع تعاقدي متنوع في انتمائه الديني»؛ لأنها لم تكتف بالإعلان في البند رقم (2) عن أن كل الأطراف الموجودة في يثرب أمة واحدة، بل أعلنت صراحة في البنود من رقم (25إلى35) أن اليهود الذين حالفوا المسلمين (أمة مع المؤمنين)، «وليسوا جماعة سياسية منفصلة، فهم يشكلون أمة بالمعنى السياسي وليس العقدي (لليهود دينهم وللمسـلمين دينهم)، فيكـون المجتمع الجديد أمة واحدة بالمعنى السياسي وأمتين بالمعنى العقدي» .
إن هـذا العيش في إطار سياسي واحد يمكن أن يكون مقدمة لانضمام اليهود إلى أمة الإجابة، وهو أمل راود النبي على ما يبدو بقوة في السنة الأولى لمقامه بيثرب .. وفي اعتقـادي أن ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه «الأموال» عن اليهود حينما قال: «فإنما أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم، فأما الدين فليسوا منه في شيء، ألا تراه قد بين ذلك فقال: لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم»، يندرج تحت مفهوم الأمة بالمعنى السياسي لا المعنى العقدي.
وأود أن أشير إلى مفهوم «الأمة» من وجهة نظر المستشرق « مونتجومري واط» حيث يقول: «إن فكرة «الأمة» كما جاء بها الإسلام هـي الفكرة البديعة التي لم يُسبق إليها، ولم تزل إلى هـذا الزمن ينبوعا لكل فيض من فيوض الإيمان يدفع المسلمين إلى «الوحدة» في «أمة» واحدة، وقد تفرد الإسلام بخلق هـذه الوحدة بين أتباعه فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والهنود والمغول والصينيين والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار، وتفاوت المصالح، ولم يخرج من حضرة هـذه «الأمة» أحد لينشق عليها، ويقطع الصلة بينه وبينها» ؛ لأنها قائمة على أساس أيديولوجي عالمي جديد.
ثالثاً: الأخلاق الاجتماعية
حين قدم الرسول المدينة وجد فيها جماعات متفرقة، متناحرة، فكون منها مجتمعا جديدا موحدا يختلف في جميع مناحي حياته عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني حينئذ، لأنه ارتكز في بنائه على الإسلام الذي حارب العصبية وهدم المبادئ الفاسدة، والنـزاعات الضارة، وقضى على المشاحنات، والعداوة التي ولدتها، وأقام بناء المجتمع على أسس واضحة ودعائم قوية، سقطت معها القيم الاجتماعية الجاهلية التي كانت سببا في التناحر والظلم، وجمع بين المسلمين برباط وثيق هـو الإيمان.
فالبند الأول من «وثيقة» المدينة ينص على أن الإسلام هـو وحده الذي يجعل منهم أمة واحدة، وأن جميع الفوارق والمميزات فيما بينهم تذوب وتضمحل ضمن نطاق هـذه الوحدة الشاملة، يقول : «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس»، وهو أول أساس لا بد منه لإقامة مجتمع إسلامي حضاري متماسك فيه التكافل والتضامن الذي بين المسلمين وغيرهم.
– التكافل بين العشائر والطوائف من خلال بنود الوثيقة :
خصص النبي الجزء الأول مـن «وثيقة» المدينـة مـن البنـد رقم (3إلى 11) للكيانات العشائرية، واعتبرت المهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم، حيث ينص البند رقم (3) على «أن المهاجرين من قريش على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين»، أما الأنصار فنسبتهم إلى عشائرهم فتقول -الوثيقة-: «وبنو… على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وذكر العشـائر لا يعني اعتـبارها الأساس الأول للارتباط بين الناس، ولا يعني الإبقـاء على العصبية القبلـية ، فقد حرم الإسـلام ذلك. قـال:﴿ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَـا إِلَى عَصَبِـيَّةٍ» ﴾ ، وإنما للاستفادة منها في التكافل الاجتماعي.
وعلى هـذا الأساس نجد أن بنود «الوثيقة» من رقم (3إلى11) اقتصرت على العشائر الداخلة في الإسلام، وهو ما يؤكد لنا مدى سعي النبي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين المؤمنين على مستوى القبائل والعشائر التي كانت تشكل عصب الحياة الاجتماعية آنذاك، يتضح لنا ذلك جليا من تأكيده عليه السلام في كل بند من البنود التسعة على بعض الأعراف القبلية المتأصلة في العادات الجاهلية والتي لا تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الجديد مثل دفع الديات، وفداء الأسرى، باعتبارها التزامات مالية يؤديها أفراد كل عشيرة، وطائفة من المؤمنين بالمعروف والقسط ، لأن نظام خزانة الدولة لم يكن قد وجد بعد.
نلاحظ هـنا إذا أن «نشوء الدولة الإسلامية لم يؤد وفق هـذه النصوص إلى الإلغاء التام لوظائف القبيلة الاجتماعية، وذلك أنها لم تكن شرا كلها، فأبقت «الوثيقة» لها بعض وظائفها التي تحمل معاني التعاون في الخير والتواصي بالـبر، وقد كانت تلك طريق الإسلام في تشريعاته كلها، يبقي ما كان من أعراف العرب صالحا ويلغي أو يعدل ما كان فاسدا أو متعارضا مع مبادئه الأساسية» .
أما فيما يتعلق بالفداء فقد تكررت عبارة « وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» في بنود «الوثيقة» عشر مرات من البند (3إلى12) مؤكدة أهمية التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع المديني بصفة عامة وأبناء كل طائفة من طوائف المسلمين بصفة خاصة، في إطلاق سراح أحد أعضـائهم إذا وقع في الأسر، وقد ذكر الله تعالى الفداء في كتابه العزيز مؤيدا لهذا الخلق الاجتماعي العظيم، فقال: ﴿ …حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا… ﴾ (محمد:4)، ﴿ وقال : « فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ﴾، والسؤال الذي يطرح هـنا هـو: هـل حددت «الوثيقة» الفداء بالمـال فقط؟ أم أنها تركت الأمر على عمومه؟
حينما نعود إلى بنود «الوثيقة» العشرة التي ذكرت الفداء: «وكل طائفة تفدي عانيها…» نجد أنها لم تقيد ذلك الفداء بالمال فقط، وإنما تركت الأمر عاما لكي تتمكن كل طائفة من فداء أسراها بأي طريقة من الطرق الإسلامية المشروعة، كالفداء بالمال، أو بمقـابل أسرى للعدو بيد المسلمين، أو بمقابل خدمات، أو غير ذلك.
– المساواة:
كان الوضع الاجتماعي بالنسبة للأفراد قبل كتابة «الوثيقة» شديد التفاوت، إذ ينقسم الناس إلا ثلاث طبقات متباينة:
- أ- طبقة الأحرار
- ب- طبقة الموالي
- ج- ج- طبقة الأرقاء
ولما جاء الإسلام حارب الطبقية بكل أشكالها وألوانها، يتضح ذلك من خلال «وثيقة» المدينة، حيث ينص البند رقم (15) على «أن ذمة الله واحدة، يجـير عليهم أدناهم…»، والأمان (الإجارة) عقد من العقود الشرعية التي أمر الله بالوفاء بها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ… ﴾ (المائدة:1). وينعقد الأمان بأي لفظ من الألفاظ كأمنتك، أو أجرتك، أو لك علي عهد…)، أو ما شاكل ذلك، كما ينعقد بالإشارة من الرجل أو المرأة، والعبد أو الحر، والغني أو الفقير، بدون تمييز، حطم البند رقم (15) كل موازين الجاهلية وأعلن مبدأ المساواة.
وقد طبق الرسول مبدأ الأمان (الجوار) في الواقع تطبيقا عمليا ولم يكن فرضا خياليا، وعلى هـذا شواهد كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- أمان المرأة
﴿ أجارت أم هـانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، يوم فتح مكة ، رجلا مشركا، فأقر رسول الله جوارها وقال: « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هـَانِئٍ ﴾ .
﴿ أجارت زينب بنت رسول الله زوجها العاص بن ربيع الوثني حينما استجار بها فأجارته.. وأعلنت على الناس الخبر وهم يصلون، قائلة: أيها الناس «إني قد أجرت العاص بن الربيع..» فقال رسول الله بعد فراغه من الصلاة: «أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعـتم إنه يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ﴾ .
قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة:6).
2- أمان العبد
﴿ عن الفضيل بن زيد الرقاش قال: حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرمى عبد منا بسهم فيه أمان، فخرجوا فقلنا ما أخرجكم، فقالوا أمنتمونا، فقلنا: ما ذاك إلا عبد، ولا نجيز أمره. فقالوا: لا نعرف العبد منكم من الحر.. فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه نسأله عن ذلك، فكتب: إن العبد رجل من المسلمين ذمته ذمتكم ﴾ . يقول صبحي محمصاني : يصح أمان المـرأة والأعمى، كما يصح أمان العبد في القول السائد، ويستند جواز عهد الأمان إلى نص القرآن الكريم: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ… ﴾ (التوبة:6)
كذلك يستند إلى قول الرسول : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» ﴾ وهذا من نتائج المساواة في عصمة النفس بين الناس جميعا بوجه عام وبين المسلمين بوجه خاص» .
وهكذا استطاعت «وثيقة» المدينة تحوير عرف الجوار الذي كان سائدا عند القبائل منذ القديم، وجعلته خاضعا للتماسك الإسلامي، الذي حارب العصبية القبلية وحطم كل الموازين التي نصبها البشر، وأقر ميزانا سماويا عادلا هو قول الله تعالى: ﴿ …إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ… ﴾ (الحجرات:13) وقول الرسول : ﴿ … وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ .
أما منح الأمان في حالة الحرب فقد قيدته «الوثيقة» في البند رقم (17) الذي قرر «أن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم»، والمراد أن حالهم وصفتهم واحدة، لا تختلف بل هـي على استقامة وعدل بحيث لا يطلب أحد أن يتميز عن غيره ، فإذا أعلن طرف ما الحرب على المسلمين فإن سائر المؤمنين يصبحون في حالة حرب مع الخصم ولا يمكن لفرد منهم مهادنته؛ لأنه مرتبط بالسياسة العامة للمؤمنين ، وكذلك لا يمكن أن يشترك البعض في الحرب ويبقى البعض الآخر في حالة سلم مع العدو، لأن عقد السلم مسألة جماعية لا يجوز أن تنفرد بها قبيلة دون الأخرى .
– مساواة الجميع أمام القانون
نقصد بالمساواة أمام القانون: أن يكون الأفراد جميعا متساوين في الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بحيث يتمكن كل شخص من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون ويخضع لجميع التكاليف التي يفرضها القانون على الأفراد .
لذا نجد أن النبي لم يلبث أن عقد مع مختلف الأطراف في المدينة «وثيقة» مكتوبة أقرت مبدأ مساواة المخالفين بالمسلمين أمام القانون دون هـضم لحقوقهم وواجباتهم، وهو الأمر الذي لم تصل إليه شريعة من الشرائع السماوية السابقة ولم يسبق له مثيل في تاريخ أي أمة من أمم الأرض، ولم يرق له قانون وضعي لا في القديم ولا في الحديث.
فالناس جميعا سواسية أمام القانون الإلهي، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، المسلم والذمي، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هـُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة:8).
وقد طبقت «وثيقة» المـدينة هـذا المفهوم عمليا في صـدر الإسلام في المجتمع الذي أنشأه محمد فحطمت بذلك التفرقة العنصرية والتمايز بين أعضاء المجتمع المديني لما اعتبرت جميع الأفراد المتعاقدين في يثرب متساويين في الحقوق والواجـبات العامة. وليس في القانون أي تمييز لأي فئة كيفما كانت أمام مغانـم الحياة العامـة ومغرمها في المدينة؛ لأن «المبدأ الإسلامي العادل هـو الغرم بالغنم ، وإن كان الله تعالى قد حمل المسلمين عبء التضحية والفداء والموت لإقامة دولة الإسلام» . لذلك نجد أن «وثيقة» المدينة قد جسدت في بنودها رقم (24 و25إلى35 و37 و38 و39 و41 و43 و44 و45 و45ب و47) التحام (الآخر) (اليهودي) بالمسلم الذي «أصبح جزءا أصيلا في الأمة والرعية المتحدة لهذه الدولة الإسلامية» التي قامت على أساس العدل والإنصاف الذي يحكم عـلاقة الناس بعضهم ببعض، قال تعـالى على لسـان سيدنا محمد (: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ… ﴾ (الشورى:15).
﴿ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَسَـوَّى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ ﴾.
هـذا فيما يتعـلق باليهود، أما فيما يتعلق بالمسلمين فقد جاء الإسلام واضعا لأساس المساواة بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ… ﴾ (الحجرات:13)، ﴿ وقول الرسول : يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى ﴾ .
أما فيما يتعلق بالمسلم و(الآخر) – اليهودي، والوثني – فالمساواة قائمة بينهم على أساس القيمة الإنسانية المشتركة، فالناس جميعا متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسئولية، وأنه ليس هـناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني وخلقها الأول، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً… ﴾ (النساء:1).
فالكـل سـواء، لا فوارق ولا طبقية بينهم وبين بعضهم إلا طبقا للمعايير الموضوعية التي قررها الدستور الإسلامي والمتمثلة بالإيمان والعمل الصالح، وهذا ما أكدت عليه «الوثيقة» في بنودها التي ساوت بين جميع سكان المجتمع المديني وفق المعطيات الجديدة.
إن مبدأ المساواة أمام القانون بين كل من شملتهم «الصحيفة» يمكن إجماله في الآتي:
- المساواة في النفقات المالية
- المساواة في العمليات الحربية الدفاعية عن المدينة من أي عدوان خارجي
- المساواة في واجب منع إجارة العدو ومن نصره
- المسـاواة في الانتسـاب إلى الأمة
- المساواة في معاملة كل طرف من المتعاقدين لحلفاء (الآخر)
كما ساوت «الوثيقة» بين جميع الأطراف المتعاقدة على اختلاف أعراقها وانتماءاتها الدينية في العيش داخل حدود الدولة الإسلامية آمنين على أموالهم وأنفسهم من أي اعتداء قد يهددها بالخطر، حيث ينص البند رقم (39) على «أن يثرب حرام جوفها لأهل هـذه الصحيفة»، فالنص صريح في تحريم الحروب والقتال بين القبائل والعشائر، وتثبيت السلم في المدينة، التي رسمت حدود حرمها ببعض العلامات البارزة في أطرافها.
– مراعاة حق الجار :
اهتمت «الصحيفة» بتوثيق الروابط بين الناس وتقوية العلاقات بين الجيران إيمانا منها بضرورة التقريب بين الأسر الإنسانية بكل وسيلة متاحة، فجعلت صلة الجوار جنبا إلى جنب مع صلة الإنسان لأقرب المقربين إليه وهي نفسه، على أن لا يسبب هـذا الجار ضررا ولا إثما، وقد بلغ الأمر في الإسلام أن جعل إكرام الجار آية من آيات الإيمان الصادق والتدين الأكيد، ﴿ قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ» ﴾ لكي تسود المجتمع المديني علاقات سليمة، ترتكز في الأساس على التعاون على البر، ورعاية الفضيلة ومنع الأذى، وإقامة الحق بين الناس جميعا، حيث ينص البند رقم (40) على «أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»..
وبذلك قصدت الوثيقة كل المتسـاكنين في المجتمع المديني الجديد دون استثناء لأي طرف من الأطراف المتعـاقدة على الطرف الآخـر، كما يعتبر هـذا البند دعوة إلى التحرر من رواسب الماضي -الجاهلي- ومخلفاته ودعوة حضارية إلى التكافل الاجتماعي المقيد في حدود مقتضيات القانون، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ… ﴾ (النساء:36).
فما أعظم المشاعر الإنسانية الفياضة بالبر والرحمة والإحسان التي أبرزتها «الوثيقة» فيما يتعلق بحق الجار «وأن الجار كالنفس» بدون تمييز بين مسلم وكافر، فقد جعل هـذا البند الأمر عاما طبقا لما جاء في الحديث الشريف المرفوع حيث ﴿ قال : «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» ﴾ وهذا كان له انعكاس إيجابي على واقع الحياة العملية في المجتمع الإسلامي من مراعاة للإنسانية والعلاقات الطيبة وسمو العشرة، بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين.
إن غاية الرسول الآنية من هـذه «الوثيقة» إيجاد مجتمع موحد تربطه أواصر الأخوة الإنسانية، والمودة والرحمة، والعدالة الاجتماعية في الشئون العامة للدولة الإسـلامية الجديدة، وقد شدد على هـذه المعاني السامية، ﴿ قال عمر، رضي الله عنه، سمعت رسول الله يقول: «لا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ» ﴾، بل وزاد الأمر وضوحا وجلاءً حينما قسم الجيران وحقوقهم إلى ثلاثة أقسام وبين أن للجار الغير المسلم حقا ثابتا في الإسلام، هـو حق الجوار.
وتختتم «الوثيقة» بالفقرة الأخيرة من البند رقم (47) الذي تنص على «أن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله » أي أن الله يحمي من يبر ويتقي ويتخلق بالأخلاق الفاضلة فعمل الصالحات كالبر والتقوى توصل العبد إلى رضوان الله، وتقوى الله توصله إلى الفوز بسعادة الدارين، فمن كان عمله لله فإن الله يكون جارا لـه ومحمد أيضا يكون جارا له.
رابعاً: ضمان الأمن لطوائف المجتمع
إن من أبرز القضايا التي كانت تؤرق المجتمع المديني أثناء الهجرة وقبل كتابة «الوثيقة» قضية انعدام الأمن وسيادة ظاهرة الثأر، حيث كان المجتمع منفرط العقد، وكان نظام القبيلة يقوم مقام الدولة، والعصبية هـي القانون الأساس الذي تتفرع عنه كافة الأحكام واللوائح المطاعة، شعارهم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، بالمفهوم الجاهلي، وبلغ أمر الأخذ بالثأر من القداسة في نفوسهم درجة القيم الدينية… ولما جاء الإسلام آخى بين الناس، وأزال ما بينهم من العداوات، وسلَّ ما في قلوبهم من السخائم، وقضى على خرافة الهامة، وعدها من أباطيل الجاهلية، ﴿ قال : « لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هـَامَةَ وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ » ﴾ .
وقال عن الذحل: ﴿ إِنَّ أَعْـدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾، كما وضع «صحيفة المدينة لتغير القانون الذي كان سائدا قبل كتابتها، فعمل على محاربة البغي والظلم، وحرم الثأر، وبيَّن أن القتل «بالقود» إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وبذلك لم يصبح الثأر أمرا يتحول إلى ثأر يجر ثأرا كما كانت الحال في القبيلة العربية من قبل، حيث لم تكن هـناك سلطة لها قوة القهر.
وجاء في الوثيقة أنه على المؤمنين تحمل المسئولية في الأخذ على يد البغاة والمعتدين والمفسدين، في البند رقم (13)، و«أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسـيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم»؛ وفي البند رقم (21): «وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه».
– منع البغي:
لقد أكد هـذا البند على مسئولية الأمة المدينية، كمجتمع سياسي قائم على السلم الأهلي، بما يعنيه من الوقوف في وجه الظلم والإثم والفتن السياسية التي تحصل بين أفراد هـذا المجتمع، فأيديهم جميعا عليه ، «ولو كان ولد أحـدهم» وهذا يعد تطورا هـائلا في التاريخ البشري حينما عدل الرسول شعار العرب في جاهليتهم من «نصر الأخ ظالما أو مظلوما» إلى «نصره ظالما بردعه عن ظلمه فذلك نصره».
وكان لا بد من النص على هـذا الموضوع والتأكيد عليه؛ لأن البناء القبلي هـو الذي يجعل للظالم سندا وسطوة من قبيلته، وطالما أن «الوثيقة» أقرت البناء القبلي في المجتمع، فـلا بد من سـلبه كل شروره وآثامه وأن لا وجود للقبيلة أمام الشرع في تأييد الظالم ونصره، فوحدة الأمة وتماسكها يتجلى في مواقفها من الجرائم المخلة بالأمن.
لذا نجـد أن «الوثيقة» أكـدت على إبراز دور المؤمـنين في البند رقم (21) حيث ينص على أنه من «اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة… وأن المؤمنين عليه كافة….» أي أن من قتل بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل إلا إذا اختار أهل القتيل أخذ الدية بدل القصاص أو وقع منهم العفو .
– حق الحياة:
لقد استطاعت «الوثيقة» القضاء على الفتن والعداوات وصيانة المجتمع المديني حينما قررت في البند رقم (21) أن القصاص نازل بالجميع، وأن القود من القاتل أمر لا مفر منه، وأن الحيلولة دون الجريمة أيا كان نوعها واجب، ولا يحل للمؤمنين إلا القيام على الجاني ولو كان ولد أحدهم «وهذا ضرب من إيجاب التكافل تشريعا لاستئصال شأفة الجريمة في المجتمع عملا على استقرار الأمن في الداخل» ، وتثبيت لسيادة القانون الإسلامي الجديد الذي حرم قـتل النفس إلا بالحـق، فأصبح القتل من الكبائر، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (النساء:93).
وبالتالي ألغى هـذا البند ذاك العرف الجاهلي الداعي للثأر، وحفظ الحياة ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ… ﴾ (البقرة:179)، وحرم الاقتتال بين ذوي القاتل والمقتول؛ لأن تنفيذ القانون أصبح ساري المفعول يسهم الجميع في تحقيقه لمصلحتهم وتنفيذًا لقانون القود (القصاص) العادل لا الثأر الجامح والقتل الباغي، فجعل العقاب على قدر الجريمة، وجعل كل مرئ مأخوذا بذنبه وحده، ولا يجوز لأحد حمايته أو مؤازرته بالدفاع عنه أو السعي في تخليصه، مهما بلغت درجة قرابته له، وهذا ما تناوله البند رقم (22) حيث ينص صراحة على:
أ- منع إيواء المجرمين
هذا القانون الذي لم يعرف النور إلا في القرون المتأخرة في التشريعات الوضعية، عرفته الدولة الإسلامية الأولى قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، فمنعت إيواء المجرمـين والدفاع عنهم وحمايتهم واعتبرت إيواء المجرمين جريمة كبيرة تخرج صاحـبها من دائرة الإيمـان بالله واليوم الآخر، لا يقبل من صاحبها لا فريضة ولا نافلة ، بل ويعتبر من الذين يضادون الله في أمره، ﴿ قال : «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ» ﴾، ﴿ وقال: «…فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ»﴾ «لأن هـذه الجريمة تؤدي إلى اضطراب المجتمع، واختلاله والطمع في النجاة من العقوبة، وإذا كان المجتمع محتاجا إلى الطمأنينة في حالات السلم فإنه إليها في حالات الحرب أحوج» .
ب- منع الغدر
يقرر البند رقم (36 ب) «أنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هـذا». والفتك «ركوب ما هـم به من أمور ودعت إليه النفس»، ورجل فاتك: جريء، وفتك بالرجل فتكا انتهز منه غرة فقتله أو جرحه، وقد كانت العرب ترفع للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .
إن هـذا البند يعد استمرارا للبندين رقم (13 و21) فيما يتعلق بالبغي والفساد والغدر والقتل والثأر الجامح لأتفه الأسباب، فهو يقرر أن حق الثأر مرتبط فقط بالقتل، أما ما عدى ذلك من جروح فعلاجه هـين لا يرقى إلى سفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل؛ لأن دماء البشر أغلى من أن تهدر ظلما نتيجة إرادة ظالمة وقوى متغطرسة، فالقضاء وحده هـو الذي يقرر العقوبة المناسبة ضد الجاني، بحيث إنها لا تسري إلى الأقارب والعشيرة.
وإذا كانت الطريقة التي يتم بها تمكين ولي المقتول أو مساعدته غامضة وغير معروفة، فإن «الوثيقة» التي وضعها الرسول وطبقها وفق الحكم الجديد للمجتمع المديني تقرر أن سند ذلك إلى الحكومة ونظام قضائها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فليس لأحد أن يثأر بالقتل من تلقاء نفسه، وإنما القضاء هـو الذي يصدر الحكم وتنفذه الدولة تحقيقا للعدالة، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ… ﴾ (المائدة:45). وهذا بخلاف ما كان عليه حكام اليهود، فقد كان بنو النضير يفضلون على بني قريظة في الدماء، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله فحملهم على الحق فجعل الدية سواء.
والملاحظ أن هـذا الإجراء من الرسول المتمثل في جعل المحافظة على الأمن -مبدئيا- مسئولية جماعية، تبدي نحوه المحافل الدولية في هـذا العصر اهتماما كبيرا، وقد ظهر هـذا الاهتمام جليا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي انعقد في استكهولم سنة 1965م، حيث تناول البحث دور الجمهور، والأسرة، والمدرسة، في الوقاية من الإجرام.
أما المؤتمر الرابع للأمم المتحدة الذي انعقد في «كيوتو» سنة 1970م فقد خصص القسم الثاني منه لبحث هـذا الموضوع المهم تحت عنوان «مساهمة الجمهور في منع الجريمة والسيطرة عليها»، حيث أكد المؤتمر «أهمية المساهمة الجماهيرية في مكافحة الجريمة، وعلى الحكومات أن تؤيد المساهمة الشعبية في ذلك وتدعمها، كما اهتم المؤتمر بتوعية الجماهير بأخطار الجريمة ومسئوليتهم عن منعها» .
والموضوع نفسه بحث في المؤتمر العربي الذي انعقد بالكويت سنة 1970م، الذي تلاقت وجهات النظر فيه حول بعض الاتجاهات الرئيسة، ومن ذلك مثلا ما رآه المؤتمر من أن في أحكام الشريعة الإسلامية وفي التقاليد العربية الأصيلة خيرا معينا على قيام الجمهور بدور فعال في مساندة القانون لمنع الجريمة وضبطها.
وهذه الدعوة الدولية إلى الاهتمام بمساهمة الجماهير في كفاح الجريمة تعد إحياء وتنمية وبعثا لتلك السنة التي سنها النبي بعد أن تبين للعالم «أن أي جهود رسمية لمكافحة الجريمة يمكن أن تفشل ما لم تلق مساندة الجمهور» ، وهذا واضح في خطاب «وثيقة» المدينة في بنودها الآنفة الذكر، حيث اعتبرت الجمهور الأساس في حفظ الأمن في المجتمع المديني الجديد.
خامساً: مسئولية الدفاع المشترك
هـاجر الرسول إلى المدينة وهي تموج بالفتن والحروب والأحقاد الداخلية والخارجية، فاستطاع من خلال «وثيقة» المدينة القضاء ولو بصورة مؤقتة، على تلك الخلافات، وحول المدينة إلى وطن آمن للمسلمين واليهود والمشركين، وللنازحين إليها من أي قبيلة كانوا ولأي عنصر انتسبوا، عربا أو عجما، فظهر لأول مرة معنى الوطن، يتساوى فيه جميع الناس من غير نظر إلى الأحساب والأنساب والعصبيات والعقائد.
وحَّدت «وثيقة» المدينة بين أهل الأديان والأجناس، وجعلتهم جميعا مواطنين مكلفين بالدفاع عن الوطن أمام أي اعتداء يفاجئ المدينة من الخارج، فالبنود رقم (24 و37 و38 و44 و45 و45ب) تنص صراحة على تحمل أهل «الصحيفة» مسئولية الدفاع عن المدينة «وتؤكد على توحيد الموقف السياسي الدفاعي الداخلي ضد العدوان الخارجي».
فإذا ضم الجيش معسكرين، واحد للمسلمين وآخر لليهود، كان على كل معسكر أن يتكفل بنفقاته، فيبتاع الأسلحة ويطعم الجند من ماله الخاص. أما أن ينفق المسلمون على اليهود إذا هـم وقفوا معهم لقتال عدوهم، فذلك ما نفته «وثيقة» المدينة في البندين رقم (24 و38) اللذين ينصان على «أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» ينفقون من أموالهم على مقاتليهم كنفقة المؤمنين على مقاتليهم، سواء بسواء، مهما بلغ حبهم للمال وحرصهم الشديد على عدم إنفاقه، فقد أكدت «الوثيقة» وبإلحاح على اليهود المشاركة الإيجابية في تحملهم أعباء نفقات دفاعهم عن الأرض التي يعيشون فيها، والوقوف مع المؤمنين جنبا إلى جنب ضد أي عدوان خارجي يهدد أمن المجتمع المديني وسلامته.
وعلى الرغم من سيطرة اليهود الغالبة على الناحية الاقتصادية في المدينة، في بداية الأمر، حيث كانوا يسيطرون على السوق التجارية ويتصرفون بخيرات المدينة وأموالها، ويتحكمون بالسلع فيحتكرونها ليرفعوا الأسعار، ويستغلون حاجة الناس فيرابون أضعافا مضاعفة، رغم هـذا كله نجد أن «الوثيقة» تؤكد المساواة بينهم وبين المؤمنين في عملية الإنفاق ماداموا محاربين، وتنص على الاستقلال المالي لكلا الطرفين، حيث يقرر البند رقم (38) «أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم..».
وقـد ﴿ روى أبو داود أن النبي خرج في غزوة أحـد حتى انتهى إلى رأس الثنية، التفت فنظر إلى كتيبة خشـناء لها زجـل خلفه، فقال: «ما هـذه؟» قالوا يا رسول الله هـؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود، فقال : «لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك» ﴾ .. وروى ابن إسحاق ﴿ عن الزهرى ، أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله : «ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم» ﴾ .
يتبين من خلال هـذه النصوص أن التناصر بين من شملهم العقد يقتصر على المدينة فقط ولا يمتد إلى خارجها، فالبند رقم (44) يحدد بجلاء ووضوح موطن الدفاع المشترك بين المتعاقدين، حيث ينص على «أن بينهم النصر على من دهم يثرب ». هـذا التناصر لا يقتصر على الاشتراك بالأموال فقط كما ورد في البنود رقم (24 و38 و37) وإنما يؤكد ضرورة بذلها لتوفير العتاد الحربي لكل القادرين على مواجهة أي عدوان خارجي قد يدهم المدينة من قبلهم، طبقا لما ورد في البند رقم (45ب) حيث ينص أنه «على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» من بذل الأموال والأنفس.
لقد أدرك اليهود قيمة الفرق بين الحرب في سبيل الله والحرب في سبيل الوطن، فهم لم يلزموا بالحرب مع المؤمنين دفاعا عن دينهم، ولكنهم ملزمون بالحرب إذا هـاجم المدينة مهاجم يريد هـلاكها، فإن المنفعة مشتركة حينئذ ولا يمكن أن يتخلوا عنها، وهكذا يكون موقف المشركين.
فحدود التحالف السياسي بين المسلم والآخر «اليهودي والوثني» يقتصر على من دهم يثرب، فلا دخل لهم في حرب العقيدة ولكنهم مطالبون بالحرب دفاعا عن الأمة وهنا روح السلام بين الأديان، فالأرض يوم تحكم بشريعة السماء، فسوف ينعم بها المسلمون وغير المسلمين؛ لأنه ليس من الحكمة أن تكون دماء المسلمين وأعراضهم وأرواحهم وأموالهم مستباحة مهدورة وأموال غيرهم وممتلكاتهم وأعراضهم مصونة..
وخلاصة القول: إذا كانت «الوثيقة» قد جعلت مسئولية الدفاع المشترك واجبا على جميع متساكني المدينة فإنه وبالمقابل منحتهم حقا لا يقل أهمية عن ذلك الواجب، وهو مساواتهم جميعا أمام القانون، دون النظر إلى الدين أو العرق، وهذا ما نجده واضحا في بنود «الوثيقة».
وثيقة المدينة وأثرها الحضاري في السلام العالمي
أولاً: التسامح الديني
لم يعرف الغرب الحرية الدينية ولا التسامح الديني إلا منذ قرن ونيف، وذلك بعد قرون مظلمة من التعصب الديني والاضطهاد والمجازر الرهيبة، ومسلسل التناحر الديني بين اليهود والنصارى ، والحرب العالمية الدينية بين الإمبراطوريتين العظميين، الفرس والروم.
وفي ظل ذلك الوضع القائم ، بزغت شمس الإسـلام من جزيرة العرب الوثنية، التي لم يكن وضع أهلها أحسن حالا من وضع غيرهم – اليهود والنصارى – لأن القريشيين لم يتحملوا مشاهدة صلاة رسول الله فتآمروا عليه .
ونتيجة لذلك الظلم والعدوان القائم على التعصب الديني والإرهاب الفكري ، أعلن الإسلام بكل صراحة ووضوح عداوته للتطرف والغلو، سواء في الدين أو في التعامل الأخلاقي البشري، متوخيا في دعوته أسلوبا حضاريا راقيا يقوم على مبدأ التسامح ويندد بالتعصب الديني والإرهاب الفكري، وقد أعلن القرآن ذلك بصراحة ووضوح في قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ… ﴾ (البقرة:256)
والشواهد النصية على هـذا التوجه الإسلامي كثيرة وهي تتوافق مع بنود «دستور الدولة الإسلامية في المدينة الذي أقر مبدأ التسامح بين جميع الأطراف المتعاقدة من -المسلمين، واليهود، والوثنيين- وترك للإنسان حريته في اختيار فكرته، لأن دولة الإسلام دولة «الحرية» لا «الحتمية»، قامت على أساس إنساني مفتوح ﴿ …فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ… ﴾ (الكهف:29) فهي لا تصادر الأفكار والعقائد الأخرى، وإنما تدفع العدوان من جانب أصحاب تلك الأفكار والعقائد فحسب ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هـُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (الممتحنة:9).
فإن توقف العدوان فقد تقدست حرمات الإنسان ﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (الممتحنة:8)، وبكل جلاء ووضوح يصرح «دستور» الدولة الجديدة في بنوده من رقم (25) إلى رقم (35) أن لكل طرف من الأطراف المتعاقدة دينه ومعتقده، يمارسه بكل حرية في ظل النظام الجديد لهذه الدولة الفتية.
لقد أدى « الدستور » واجبه في رفع الظلم ودفع الفساد عن الإنسان، ولا شك أن لروح التسامح التي طبعت بنوده أثرا عظيما في ذلك، فالدستور بمضمونه وروحه محاولة جادة لإزالة التمييز العنصري وتنقية العلاقات البشرية من سموم التحاسد الفردي والتطاحن القبلي والتناحر الطائفي والتعصب الديني. «فالتسامح من خصائص دين الإسلام، وهو أشهر مميزاته، وإنه من النعم التي أنعم الله بها على أضداده وأعدائه، وأدل حجة على رحمة الرسالة الإسلامية المقررة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء:107)» .
وقد ترجم «دستور» المدينة تلك الرحمة بما أقره لليهود من العيش بأمن وسلام إلى جانب المسلمين، يمارسون معتقداتهم وأمور دنياهم الخاصة بهم، التي تضاد معتقد الدولة الإسلامية، التي أرسى دعائمها محمد ( على التسامح والتناصح والبر دون الإثم، معترفا (للآخر) اليهودي بأنه «أمة مع المؤمنين»، دون الالتفات لعقيدته.
وهنا يتبين لنا جليا أن احترام عقائد الآخرين وعدم إكراههم هـو أساس التسامح؛ لأن الإكراه في الدين لا يجوز للأمور التالية:
1- النص الصريح، حيث يقول الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ… ﴾ (البقرة:256)؛ ويقول تعالى: ﴿ …أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس:99). حيث يتنافى الإكراه مع طبيعة العقيدة نفسها، من حيث كونها عنصرا نفسيا، ومن المحال تكوين أو تأسيس حقيقة نفسية بالإكراه .
فالقرآن يوصـي بالتسامـح إلى أقصى حد ممكن في الأمور الدينية، كما يوصي بحرية الفكر واحترام جميع الآراء، ويستنكر أي اعتداء على المعتقدات، سواء منها الفردية أو الجماعية، ويؤكد الثعالبي: «إننا نجد ذكر احترام الديانات الأخرى وحرية المعتقدات واحترام جميع الآراء في ست وثلاثين سورة، وخمس وعشرين ومائة آية. فالتسامح يمثل حينئذ الفكرة الأساسية في القرآن» .
2- المعاملات الدنيوية التي لا علاقة لها بالانفعالات الدينية، وهي المعاملات التي تعرض بين فريقين مختلفين في الدين متجاورين في مـكان، مثل ما عرض من المعاملـة بين المسـلمين واليهود في المدينة وما جاورها. وقد تجلت سماحة الإسلام في بنود «الوثيقة» من خلال معاملة المسلمين لليهود، وخاصة إذ اشتركوا معهم في مجالات الحياة، واتبعوا المؤمنين فإن المؤمنين ينصرونهم، ويمدونهم بالمساعدة والمعونة وبكل ما يحتاجون إليه، فقد نصت «الوثيقة» في البند رقم (16) على: «وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وهذا دليل بيِّنٌ على أن الإسلام قد أرسى مبدأ التواصل الحضاري بصورة مطلقة، دون تحديد للطرف الآخر، الذي يتم التعاون معه على البر والتقوى، إزاحة للعقبات التي تحول دون تحقيق هـذا المبدأ العظيم، حضارة وإنسانية، فالاختلاف في الأديان لا يحول دون البر والصلة والضيافة «وأن البر دون الإثم» كما ورد في «الوثيقة».
ومن مظاهر التسامح الديني: أنه كان من بين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة، فلما جاء اليهود يطلبونها، أمر النبي بتسليمها لهم . ويدل هـذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول من مكانة.﴿ يقول النبي : لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ ﴾، من هـذا الجانب السلوكي وما يتفرع عنه من أبعاد ترتبط بالإسلام في شموليته وتكامله ينبثق «التسامح» سمة مميزة تطبع المجتمع، الذي يدعو الإسلام إلى قيامه و«التعايش» فيه بصفته دين «السماحة»، الذي لا ضيق فيه ولا تعصب ولا غلو ولا تطرف، ولا عنف ولا إرهاب، سواء مع (الذات) أو مع (الآخر).
وخلاصة القول: إن «دستور» المدينة، الذي تعاقد فيه المسلمون مع غيرهم من أهل الديانات الأخرى فنشأ عن ذلك أول ميثاق -عصبة أمم- أساسه النصر للمظلوم، والنصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وحرمة الوطن المشترك، كان – هـذا الدستور- الأساس المتين للدولة العالمية، وللمعاملات الدولية القائمة على أساس الحرية للمشتركين فيه وعلى مبدأ الاستقلال، كما أنه أعطى كل ذي حق حقه، فلا ظلم ولا أنانية ولا تحيز لطرف على آخر، وإن قاعدة التسامح التي قام عليها الإسلام، فتحت أمام الأمة الإسلامية السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالأمم والشعوب، وشجعت الحضارة الإسلامية على التفاعل مع الثقافات والحضارات جميعا.
ثانياً: التعايش السلمي والتعاون بين الأفراد
إن التعايش مع الأديان بصفة خاصة، ضرورة من الضرورات الملحة التي يفرضها الحفاظ على سلامة الكيان الإنساني ويمليها الحرص المشترك على البقاء الحر الكريم فوق هـذا الكوكب، لذا نجد أن الإسلام قد سبق الأمم العالمية والمنظمات الدولية إلى إعلان نداء السلام العالمي الشامل بمقتضى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾، وندد القرآن الكريم بالإخلال بمبادئ السلم، واعتبر ذلك نزوعا مشينا إلى الشر، وسيرا على خطوات الشيطان، فذيل نداء الدخول في السلم العام بقوله: ﴿ …وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (البقرة:208) ؛ لأن السـلم هـو العلاقـة الطبيعية بين الشعوب والأمم، فالإسلام يريد أن يؤكد في ضمير الناس حقيقة مهمة وهي أن كل الناس من أصل واحد، وهو آدم، عليه السلام، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً… ﴾ (النساء:1).
– استراتيجية التعايش
انطلقت هـذه الاستراتيجية من أرضية عقائدية، حيث توجهت الدعوة الإسلامية بالنداء الإلهي إلى أهل الكتاب داعية إياهم إلى الالتقاء على كلمة التوحيد في مقابل الشرك، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ… ﴾ (آل عمران:64)، هـذا النداء يشكل أول نداء عالمي للتعايش الاستراتيجي بين الديانات. ويمكن أن نقول عنه: إنه أول نداء عالمي للتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة، عمل الرسول على تطبيقه في الحياة العملية وذلك حينما قننه في «دستور» دولته التي أعلنها في يثرب بعد هـجرته إليها مباشرة.
– الاعتراف بـ(الآخر)
أي غاية أسمى وأقرب إلى الإنسانية ودين الله من تلكم الغاية التي كان يرمي إليها الرسول في توحيد القلوب وإظهار الحقيقة- ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ – بين أهل الديانات المختلفة في الدولة الإسلامية الجديدة بالمدينة.
لقد أحدث «دستور» المدينة، الذي وضعه النبي بين جميع المتساكنين بمختلف فئاتهم ومعتقداتهم، نقلة نوعية بإخراج أصحاب الديانات المختلفة من مآزق الصراع والتناحر، حيث فتح لجميع المتعاقدين عهدا من الوئام والتفاهم والتعايش بين العقائد يقوم على مبدأ عظيم سجلته الفقرة الثانية من البند رقم (25) بإعلانها أن «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم»، وهذا يتوافق مع التوجيه القرآني لصـاحب الرسالة عندمـا أمره ربه تعالى أن يقول لمن لا يستجيب لدعوته: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (الكافرون:6)، ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ… ﴾ (الكهف:29)،
وهذا أقصى أنواع الاعتراف (بالآخرين) الذي ينطلق من الثقة، والاحترام المتبادلين، ومن الرغبة في التعاون لخير الإنسانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفيما يمس حياة الإنسان من قريب وليس فيما لا نفع فيه ولا طائل تحته.
لقد بادر النبي في «دستور» دولته، الذي جاء في شكل اتفاقية مبرمة بين جميع المتساكنين في يثرب على اختلاف أصولهم العرقية وعقائدهم الدينية، إلى إعطاء (الآخرين) المخالفين في المعتقد من الضمانات ما يبدد مخاوفهم، من أجل أن تصبح المدينة حرما آمنا للتعايش السلمي في ظل احترام جميع العقائد، حيث تضمن البند رقم (39) من الدستور «أن يثرب حرام جوفها لأهل هـذه الصحيفة» دون استثناء لأحد من سكانها، مسلمين كانوا أو يهودا أو وثنيين.
لقد كفل «دستور» الدولة الإسلامية الجديدة لغير المسلمين من التسامح المفضي إلى التعايش ليس فقط ما يكفل لهم حرية ممارسة عقائدهم، وإنما كفل لهم ما يجعلهم مواطنين في هـذه الدولة، مندمجين فيها، موفوري الحرية والكرامة، غير منعزلين ولا مهمشين، وتكفي الإشارة في هـذا الصدد إلى المظاهر التالية:
- النهي عن مجادلتـهم إلا بالتي هـي أحسن: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هـِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (العنكبوت:46)؛ لم يقف الأمر عند هـذا الحد بل تجاوز «دستور» دولة الرسول قضية الجدال، ونصَّ على أن بين جميع المتعاقدين (النصح والنصيحة والبر دون الإثم).
- حرية ممارسة العقيدة.
- إباحة مصاهرتهم وأكل طعامهم، قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ… ﴾ (المائدة:5).
لقد نقلت «الصحيفة» أهل المدينة من أجواء الحقد والكراهية والتفرقة العنصرية والعصبية القبلية إلى أجواء الاحترام المتبادل، والتسامح الديني، والتعايش السلمي، والتعاون على البر دون الإثم، والمساواة، فالناس جميعهم أمام الخالق سواء؛ لأنهم خلقوا من نفس واحدة، الإنسانية تجمعها، والآدمية تشملها.
ويمكن تلخيص أسس التعايش السلمي من خلال «الصحيفة» في هـذه النقاط:
- الرغبة المشتركة في التعايش نابعة من (الذات)، وليست مفروضة تحت ضغوط، أيا كان مصدرها، أو مرهونة بشرط مهما يكن مسببه.
- التفاهم حول الأهداف المشتركة بحيث يكون القصد الرئيسي من التعايش هـو خدمة الأهداف الإنسانية السامية، وتحقيق المصالح البشرية العليا، وفي مقدمتها استتباب الأمن والسلم في الأرض، والحيلولة دون قيام أسباب الحروب والنـزاعات، وردع العدوان والظلم والاضطهاد، الذي يلحق بالأفراد والجماعات.
- التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها.
- صيانة هـذا التعايش بسياج من الاحترام المتبادل ومن الثقة المتبادلة أيضا حتى لا ينحرف عن الخط المرسوم لأي سبب.. مهما تكن الدواعي والضغـوط، فإن الاحـتكام لا يكون إلا إلى القـيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها كما هـي محددة في «دستور» الدولة الجديدة في المدينة .
إن الباحث المتـأمل في هـذا الدسـتور ومقاصده البعيدة التي كانت وراء تلك الثوابت، التي ذكرناها، لا يخـامره أدنى شـك أنه أعظم ميثاق للتعايش السلمي بين مواطني الدولة الإسلامية، بمختلف أجناسهم وأعراقهم ومعتقداتهم. وهنا نستطيع القول: إن «الوثيقة» اشتملت على كثير من المبادئ الإنسانية السامية، كنصرة المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، والتعاون على دفع الدية وافتداء الأسرى، ومساعدة المدين، إلى غير ذلك من المبادئ التي تشعر أبناء الوطن الواحد كأنهم أسرة واحدة.
ثالثاً: رعاية حقوق الإنسان وتأكيد حرمتها
كانت حياة العرب قبل الإسلام تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم، وحب السيادة والعلو، يعيش أفراد المجتمع فيها برباط الولاء للقبيلة، توجههم تقاليد متوارثة – قطع الأرحام، وإساءة الجوار، وأكل القوي منهم للضعيف – حالت بينهم وبين الانخراط في حضارات عصرهم ومدنياته، لذا كان من أولويات الدولة الإسلامية الجديدة، التي أنشأها سيدنا محمد في المدينة، أنها رسمت للناس المنهج القويم، الذي يكفل لهم الكرامة الإنسانية، فقد كانت بمثابة فتح جديد في تاريخ البشرية، حينما نص دستورها على أرقى مضامين الحرية والكرامة للإنسان، التي تمكنه من ممارسة حقوقه وحرياته الشخصية في هـذه الحياة، معتبرا انتهاكها والاعتداء عليها جريمة تستوجب العقوبة.
لقد وضع الرسول «دستور» دولته دون خوف من ثورة شعـبية أو نتيجة لتفتح وعي الناس وقيامهم بمظاهرات للمطالبة به، أو نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع المدينة، وإنما كان بمثابة حركة إصلاح وتحرر وانعتاق من دياجير ظلمات الباطل، مبينا للإنسان حقوقه التي لا يجوز التنازل عنها أو عن بعضها؛ لأنها ضرورات إنسانية لا سبيل لحياة الناس بدونها، فردية كانت أو جماعية، ومن هـذه الحقوق:
- حق الحرية.
- حق الحياة.
- حق حرية الاعتقاد.
- حق العدل والمساواة.
- كفالة حرية الرأي.
- حق الأمن والمسكن والتنقل.
- حق الفرد في المعونة المالية (التكافل والضمان الاجتماعي).
وغيرها من الحقوق التي كفلها «دستور» دولة الرسول ، وهي في نظر الإسلام ليست فقط حقوقا للإنسان من حقه أن يطالب بها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها، وإنما هـي ضرورات واجبة لهذا الإنسان، أي أن الإسلام قد بلغ بإقراره لحقوق الإنسان إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق عندما اعتبرها ضرورات، ومن ثم أدخلها في دائرة الواجبات، فالحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان، بل هـو واجب عليه أيضا، يأثم هـو بذاته، فردا أو جماعة، إذا فرط فيها، بعكس الإعلانات السياسية والإنسانية، والدراسات الدستورية (بل والدساتير أحيانا) تركز على «الحقـوق» مع إشـارة عابرة إلى الواجبات، أو عدم الإشارة إليها إطلاقا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) المكون من ثلاثين مادة لا نجد من بينها نصا على «الواجبات» إلا في المادة (29) منه، وقد جاء الحث على الواجب في هـذا النص مقيدا غير مطلق، وفيه: « على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا».
لقد أرست «الوثيقة» حقوقاً للإنسان وواجبات عليه، في تنسيق بديع متوازن يسير في علاقات توازن بين الحق والواجب، بما يحقق للإنسانية الخير والعدالة والكرامة. فما يعد حقا للفرد أو المجتمع في «الوثيقة» هـو فرض واجب على الفرد للفرد، وعلى المجتمع للفرد، وعلى الفرد للمجتمع، وعلى الدولة للفرد والجماعة معا في النظام الإسلامي. فالمجتمع الإسلامي الجديد كلٌ متكامل يلتقي فيه الفرد بالمجتمع في نظام يحكمـه الواجب الذي يرقى إلى درجة الإلزام، وهذا ما صرحت به «وثيقة» المدينة في بنودها من رقم (3 إلى 12) وكذلك البنود (13 و16 و21 و25 و37 و39 و40) وهذا يعني أن ما للفرد أو للمجتمع من حق هـو واجب على الفرد والمجتمع يرقى إلى درجة الإلزام.
فالحرية حق لكل إنسـان وواجب على الآخرين رعـايته، وكذلك حق الإنسان في الحياة وفي التعلم وفي الرعاية الصحية والاجتماعية واجب على المجتمع كفالته، وهو واجب لا يملك المجتمـع الإغضاء عنه أو إنكاره، إذ أن حق الفرد على المجتمع واجب ملزم للجماعة، ويتضمن هـذا الواجب الرعاية والكفالة والحماية بكل أنواعها، ولا يعني ذلك مسئولية الدولة المطلقة، أو فناء شخصية الفرد في الجماعة، بل تبقى للفرد بعد ذلك شخصيته المتكاملة وحوافزه الذاتية حرة طليقة من كل قيد في كل ما يتعلق بشئونه الخاصة، أو نشاطه الخاص وفقا لحـدود الشريعة، فالرسول لم يفرق في تقريره لحقوق الإنسان وواجباته في «دستور» دولته بين غني وفقير، ومسلم وغير مسلم، وشريف ووضيع، وأبيض أو أسود، فالكل سواسية كأسنان المشط أمام القانون.
وختاماً إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس إلا وثيقة دولية صاغها بعض البشر عام 1948م، أرادوا بها أن يتفادوا جرائم الحرب البشعة التي سجلها التاريخ أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية والنصف الأول من القرن العشرين مثلما ذكروا ذلك في ديباجة الإعلان : «ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدرائها قد أفضى إلى أعمـال هـمجـية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة…»، لقد أرادوا أن يضـعوا لدول العالم مخرجا مما وصـلت إليه من انتهاكات صـارخة لحقوق الإنسان، ولكن لم يتم تطبيق هـذا الإعـلان الذي توصلوا إليه؛ لأنه لم يكن ملزما كالذي وضعه سيدنا محمد وطبقه من أول وهلة على جميع سكان الدولة الإسلامية الأولى في المدينة.
الخاتمة
هذه الدراسة التي قامت على التحليل والاستنتاج والمقارنة لبنود «الوثيقة» التي وضعها الرسول بين أهل الأديان والأجناس المختلفة في المدينة بعد هـجرته إليها، وكان لها دوراً كبيراً في السلام العالمي من خلال البعدين الاجتماعي والحضاري ، أوصلتني إلى النتائج الآتية:
- كشف موضوع «الوثيقة» بوضوح أن البعد الإنساني والحضاري في فعاليات السيرة النبوية، وأن الاهتمام بالمسألة الاجتماعية والعلاقات البشرية ليس أمرا عارضا أملته ظروف طارئة، وإنما هـو سمة أصيلة واهتمام مركزي في المشروع الإسلامي.
- وضعت «الصحيفة» نظاما متكاملا للمجتمع المديني الجديد يختلف كليا عن الأنظمة التي كانت سائدة في ذلك العصر، ولا يقل تنظيما عن الأنظمة القائمة في الدول الحديثة، إن لم يتفوق عليها في مجالات عديدة بسبقه وحسن تنظيمه ودقته.
- تعدّ «الوثيقة» أكبر شاهد على أن دولة الرسول تكونت من تنظيم اجتماعي متناسق من جميع جهاته وأطرافه، فقد اعتنت بالفرد عناية فائقة، وضمنت له من الحقوق ما يجعله يعيش بها إنسانيته في حرية، وعزة، وكرامة، وكلفته بواجبات تجعل منه شخصا مسئولا في المجتمع ينهض بمهمات تخولها مكانته وأهميته.
- فرضت «الوثيقة» حقوقا عامة على الإنسان للإنسان، بحكم علاقة الإنسانية، بقطع النظر عن اتحاد الدين أو اختلافه، كعون الضعيف، وإشباع الجائع، وتأمين الخائف، وسائر الحقوق التي تجب لمواطني الدولة الإسلامية، وإن لم يكونوا مسلمين.
- إن التسامح الديني سمة بارزة في «الوثيقة» لم تعهدها الشعوب بهذه الصفة من قبل، فالتاريخ يثبت أن اليهود قد قُهروا وشردوا في كل أنحاء العالم نتيجة التعصب، وكذلك قتل أصحاب الأخدود – النصارى- لنفس السبب؛ وأصبح أهل الأديان كلهم آمنين محميين من الإكراه الديني بنص القانون وسلطته ولكن في ظل «دستور» المدينة.
- جاءت «الوثيقة» بمفهوم جديد للمساواة وهي أنها لا تعني المثلية، وإنما تعني أن تحكم العلاقات بين الناس كافة في المجتمع قواعد عامة ومجردة، سابقة على نشأة تلك العلاقات، تساوي بينهم من حيث هـم بشر، وإن اختلفت عقائدهم.
- تعدّ «وثيقة المدينة» الدستور الذي ينظم العلاقات بين مكونات المجتمع الجديد وبين من انضوى تحته من الطوائف، والتزموا جميعاً بموجبها مسلمين أكانوا أم غير مسلمين بالتعاون فيما بينهم على إقامة العدل، والحفاظ على الأمن وحماية الدولة الجديدة من أي عدوان خارجي.
- تدلُّ الوثيقة على عبقرية الرَّسول صلى الله عليه وسلم في صياغة موادِّها، وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فقد كانت موادُّها مترابطةً، وشاملةً، وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك، وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقِّق العدالة المطلقة، والمساواة التَّامَّة بين البشر، وأن يتمتَّع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأديانهم، بالحقوق والحرِّيَّات بأنواعها.
- تضمَّنت الصَّحيفة مبادئ عامَّةً، درجت دساتير الدُّول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ، تحديد مفهوم الأمَّة؛ فالأمَّة في الصَّحيفة تضمُّ المسلمين جميعهم، مهاجريهم، وأنصارهم، وَمَنْ تبعهم ممَّن لحق بهم، وجاهد معهم، أمَّةٌ واحدةٌ من دون النَّاس.
مراجع البحث:
- أحمد راتب: قيادة الرَّسول صلى الله عليه وسلم السِّياسيَّة والعسكريَّة.
- أحمد قائد الشعيبي: وثيقة المدينة: المضمون والدلالة، كتاب الأمة.
- أكرم ضياء العمري: السِّيرة النَّبويَّة الصَّحيحة.
- أبو الحسن الماوردي : النكت والعيون (تفسير الماوردي) .
- خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط.
- السيد عبد العزيز سالم، التَّاريخ السِّياسيُّ والحضاريُّ.
- صالح العلي: تنظيمات الرَّسول صلى الله عليه وسلم الإدارية في المدينة.
- الظافر القاسمي : نظام الحكم .عبد الحميد متولِّي مبادئ نظام الحكم في الإسلام.
- عبد الناصر توفيق العطار: دستورٌ للأمَّة من القرآن والسنة.
- علي محمد محمد الصلابي :السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث.
- علي محمد محمد الصلابي: فقه التمكين .
- علي معطي: التَّاريخ السِّياسي والعسكري .
- كامل سلامة الدقس : دولة الرَّسول صلى الله عليه وسلم من التَّكوين إلى التَّمكين.
- ابن كثير، البداية والنهاية .
- ماجد عرسال الكيلاني: فلسفة التَّربية الإسلاميَّة .
- محمد الناظر، حوار الرَّسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود.
- محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السِّياسية .
- محمد رضا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- محمد عبد القادر أبو فارس: النظام السِّياسيُّ في الإسلام.
- محمد عزة دروزة: سيرة الرسول – صور مقتبسة من القرآن الكريم.
- محمد فوزي فيض الله : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويِّ في المدينة.
- محمد نور الدين: مبادئ علم الإدارة .
- الميداني، الأخلاق الإسلاميَّة وأسسها.